
كان حرياً بواقعة اغتيال اللواء وسام الحسن، رئيس شعبة المعلومات في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي اللبناني، من حيث إحكام العملية وسلاسة التنفيذ وما تردد عن وجود سيارات مفخخة أخرى في جميع المنافذ الإجبارية التي ستمرّ منها سيارة الحسن (التي كُشفت اصلاً، رغم تمويهها)، أن تعيد أذهان البعض إلى أطوار سالفة من هيمنة النظام السوري على مقدّرات لبنان.
وتلك أحقاب ‘ذهبية’ ربما، شهدت تمتّع النظام بسلطات واسعة النطاق، متعددة الأدوات، وفيرة المغانم، وعابرة للعلاقات الثنائية بين البلدين. وقبل أن يُورَّث بشار الأسد الحكم، بعد وفاة أبيه، في حزيران (يونيو) سنة 2000، ذاق لبنان، واللبنانيون، شتى صنوف التسلّط التي أدخلتها إدارات العميد محمد غانم (أوّل رئيس لاستخبارات النظام العسكرية في لبنان، ‘فرع الأمن والاستطلاع’ في التسمية الشائعة)؛ وخَلَفه اللواء غازي كنعان، الغني عن التعريف بالطبع، والذي يصحّ فيه النحت اللغوي الفريد: إنتُحر؛ والعميد محسن سلمان (قائد الوحدات الخاصة، والآمر الناهي في تسعة أعشار شبكات التسلط والنفوذ والنهب خلال أواسط الثمانينيات)؛ فضلاً عن سلسلة العلاقات الوثيقة مع ساسة وضباط عسكريين وضباط أمن لبنانيين، يُعتبر ولاء ميشيل سماحة اليوم ألعوبة أطفال بالقياس إلى ولائهم آنذاك.
بيد أنّ عودة الأذهان إلى مناخات أي من تلك الأطوار لا تعني، بالضرورة، أنّ نفوذ النظام السوري، المباشر والفعلي والمنفرد، قد عاد إليها بدوره، بصفة آلية؛ وإنْ كانت تعني أنّ ‘تلازم المسارات’ بين النظام وحلفائه اللبنانيين، والإقليميين، قد بلغ ذروة قصوى ابتداء من عملية اغتيال الحسن (وهذا نقاش آخر، توقفتُ عند ملابساته قبل أيام، في ضوء منطق أمني وعملياتي وميداني يفرض القاعدة التالية: جميع العمليات التي تجري على الأرض اللبنانية، خدمة للنظام السوري، لا بدّ أن تخضع لترخيص، أو مساعدة، أو حتى توفير أدوات التنفيذ، من جانب ‘حزب الله’ و/أو ‘الحرس الثوري’ الإيراني). ذلك لأنّ نفوذ النظام، اليوم، هو في أضعف حلقاته منذ الدخول العسكري إلى لبنان، صيف 1976؛ وهذا كان النقلة الإقليمية السياسية والعسكرية الأهمّ في تاريخ ‘الحركة التصحيحية’، التسمية الرسمية للانقلاب الذي قاده حافظ الأسد ضدّ رفاقه في حزب البعث منذ أواخر 1969، وتوّجه في 16 تشرين الأوّل (أكتوبر) 1970، حين استكمل وأعلن استيلاءه على السلطة.
ولهذا فإنّ الانسحاب العسكري السوري من لبنان، في شباط (فبراير) 2005، كان قد استكمل تلك النقلة في الوجهة المعاكسة، إذا جاز القول؛ أي في مسار تجريد النظام السوري ـ ببطء تارة، وبتسارع دراماتيكي طوراً، ولكن على نحو مضطرّد إجمالاً ـ من المغانم والأوراق والقوى والحلفاء وهوامش المناورة الإقليمية. ومن الإنصاف القول إنّ انحطاط النفوذ السوري في لبنان كان قد بدأ، سياسياً، في عهد الأسد الأب، مع سحب هذا الملفّ من يد عبد الحليم خدّام، نائب الرئيس آنذاك، وتسليمه إلى بشار الأسد كجزء من ترتيبات إعداد الفتى لخلافة أبيه. (غنيّ عن القول إنّ الانحطاط لم يبدأ لأنّ خدّام كان أرحم باللبنانيين من الأسد الابن، بل على العكس تماماً: الأخير كان في طور التلقين وألعاب الهواة، وكان خدّام أشدّ شراسة وأكثر تشدداً).
غير أنّ الضربة القاصمة جاءت مع وفاة الأسد، حين صحا اللبنانيون على الحقيقة البسيطة التالية: الوجود السوري (‘الشرعي’ و’المؤقت’ بالنسبة إلى الرئيس اللبناني السابق إميل لحود، والمؤقت ولكن اللاشرعي الذي آن أوان إنهائه بالنسبة إلى معظم اللبنانيين) ينبغي أن لا يظلّ على حاله السابقة بعد أن غاب الأسد، صانعه الأوّل، الأعلى دهاء ومكيافيللية ودموية من وريثه في الحكم.
هذه الحقيقة/ البديهة كانت تقبل، أو تصنع تلقائياً، مكمِّلها الاستطرادي، البديهي، الآخر: إذا تآكل الوجود السوري في لبنان ـ سواء نُظر إلى ذلك الوجود في مستوياته العسكرية والسياسية والاقتصادية، أو في امتداداته الأخرى الاجتماعية (العمالة السورية، التوترات بين الشعبين، انقسامات اللبنانيين…)، أو الحقوقية (اتفاق الطائف، القرارات الدولية…) ـ وكفّ عن كونه صانعاً لأوراق القوّة في صفّ النظام؛ فمن المنطقي والحال هذه أن ينقلب إلى عبء على سلطة الوريث، في العلاقة مع الجوار الإقليمي، والعالم بأسره.
ومن الإنصاف التذكير، كذلك، أنّ أولى إشارات الصحو على هذه الحقيقة/ البديهة لم تأت من وليد جنبلاط أو ‘الكتائب’ أو ‘القوّات اللبنانية’، أو أيّ من القوى اليسارية التي سوف تأتلف بعدئذ في إطار ‘اليسار الديمقراطي’؛ وطبيعي أنها أيضاً لم تأت من صفّ رفيق الحريري لأنه كان، آنذاك، أحد أخلص حلفاء النظام السوري. لقد جاءت، ليس دونما مفارقة في واقع الأمر، من مجلس المطارنة الموارنة الذي أصدر بياناً لافتاً تماماً في 20 أيلول (سبتمبر) من العام 2000، أي بعد أشهر معدودات على توريث الأسد الابن، أبدى فيه الحرص على ‘توثيق أحسن علاقات الأخوّة بين لبنان وسورية’؛ ولكنّ المغزى الأهمّ وراء البيان كان التشديد على أنّ الصلة اللبنانية ـ السورية قائمة على ‘علاقات الأخوّة’ وحدها، ليس أكثر!
وإذْ ينصف المرء ذلك البيان اليوم، فليس لأنّ المشهد الراهن يقتضي استذكار تلك الواقعة، والمفارقة خلفها، فحسب؛ بل لأنّ ما انطوى عليه نصّ المطارنة الموارنة كان أقرب إلى استبصار الكثير من التطوّرات التي سيشهدها البلد حين تغادر قوّات النظام السوري. كذلك استدعى، من جانب آخر، جملة استقطابات سياسية واجتماعية ودينية ومذهبية سوف تصبح من جديد جزءاً لا يتجزأ من خطاب، وكوابيس، الحياة اليومية اللبنانية الراهنة. وهكذا، وكما نشهد اليوم مَن يترحّم على الوجود العسكري في صفوف اللبنانيين أنفسهم (وليس عاصم قانصوه وحده، للتذكير، بل الجهة الأخرى الأعلى قبضة وسلاحاً ونفوذاً أمنياً: ‘حزب الله’)، توفّر مَنْ يناهض بيان بكركي في صفوف… مناهضي النظام السوري هذه الأيام! تلك كانت روحية البيان المضاد الذي صدر آنذاك عن ‘اللقاء الإسلامي’، المؤلف من المفتي الشيخ محمد رشيد قباني (ممثلاً لدار الإفتاء السنية)، والشيخ عبد الأمير قبلان (المفتي الجعفري الممتاز)، ومحمد السماك (ممثّل لجنة الحوار الإسلامي ـ المسيحي)، وبهجت غيث (شيخ الطائفة الدرزية).
بيان مجلس المطارنة الموارنة طالب بإعادة انتشار الجيش السوري تمهيداً لانسحابه نهائياً، عملاً بالقرار 520، واستناداً إلى نصوص اتفاق الطائف؛ وبيان ‘اللقاء الإسلامي’ اعتبر أنّ الوجود السوري شرعي ومؤقت كما قال رئيس الجمهورية، وأي موقف منه تقرره السلطات الرسمية. موقفان، إذاً، على طرفَي نقيض وعلى طرفَي استقطاب ديني واضح: مسيحي/مسلم. إلى هذا، كان الفارق بين البيانين لا يقتصر على انقسام حادّ بين ‘لا’ و’نعم’ للوجود السوري، بل تجاوز اللونَين الأبيض والأسود إلى تدرّجات للرمادي، عديدة ومعقدة! بين هذه التدرّجات، العابرة للدينيّ والمذهبيّ والسياسي بمعنى السياسة الصرفة الكلاسيكية، ما جاء في بيان مجلس الوزراء اللبناني ردّاً على بيان المطارنة الموارنة: ‘العلاقات بين سورية ولبنان ليست أمراً مزاجياً يتغير بتغيير المواقف الخارجية والفئوية، بل هي علاقة ستراتيجية تحددها الدولة بمؤسساتها الدستورية، وأنّ هذه العلاقة هي من الثوابت التي تقوم على تأكيد مصلحة لبنان أولاً، والتي تؤكد أيضاً ثبات المواقف القومية مع الشقيقة سورية وأواصر المصالح المشتركة في ما بيننا’.
بالطبع، المعادلات اختلفت جذرياً بعد اغتيال الحريري الأب، وانقلاب سواد السنّة على دمشق، وانحياز سواد الدروز إلى وليد جنبلاط بوصفه ممثّل الزعامة التاريخية على الأقلّ، حين انخرطت دمشق في تأثيمه وتجريمه. وباتت أشباح الحرب الأهلية أقلّ هيمنة على الوجدان الشعبي العامّ، بل صار من المشروع القول إنّ خريطة الولاءات المذهبية ذات التلوّن السياسي (بصدد الموقف من النظام السوري، أساساً) أقلّ تعقيداً من ذي قبل، وبالتالي أوضح في الطبيعة والتكوين والقدرة، وأيسر سيطرة في حال اندلاع صدامات مذهبية أهلية. لكنّ الحال تغيرت في الصفّ المسيحي أيضاً، والماروني منه بصفة خاصة، وكان انتساب ميشيل عون إلى نادي حلفاء النظام السوري يعيد خلط الأوراق على نحو ينتهي إلى ترسيخ ذلك الإجماع اللبناني على مبدأ كلاسيكي في المحاصصة: لا غالب ولا مغلوب!
ورغم تبدّل المواقع بين الأغلبية والمعارضة، وبين حكومة سعد الحريري وحكومة نجيب ميقاتي، زار الأخيران دمشق مثلما زارها وليد جنبلاط وحسن نصر الله؛ ولكن، في غمرة التقلبات كافة، ظلّ ميزان نفوذ النظام السوري يشير إلى فائض نقصان، وليس فائض قيمة؛ وإذا ما قيس بمعدّلات الأحقاب ‘الذهبية’، حتى أواخر التسعينيات، فإنّ النفوذ كان في حال من تآكل مضطرد. الانتفاضة السورية أكملت هذه السيرورة، بمعنى أنها شدّدت وتائر التآكل، من جهة أولى؛ وأوقعت حلفاء دمشق في حرج الاصطفاف خلف النظام رغم الأكلاف السياسية والأخلاقية الهائلة وراء اضطرار كهذا، من جهة ثانية. وفي الخلفية الأخرى، السياسية ـ الاجتماعية لواقع المحاصصة، أثبتت الانتخابات النيابية الأخيرة أنّ الميول الشعبية العامة على حالها تقريباً عند الطوائف المسلمة، فصوّتت كلّ طائفة لمرشحيها: السنّة بنسبة تجاوزت 88 بالمئة، والشيعة 90 بالمئة، والدروز 92 بالمئة. ولكنّ الميول كشفت، في الآن ذاته، عن انقسام في صفوف المجموعات المسيحية المتنازعة، بحيث آل إلى السنة والدروز أمر ترجيح فريقَيْ ‘الكتائب’ و’القوات اللبنانية’، حلفاء 14 آذار؛ وتولى الشيعة دعم مرشحي الجنرال عون، المسيحيين.
ولقد انصرم زمن شهد تطبيق النظام السوري ستراتيجية تخويف المجتمع السوري من أخطار حرب أهلية على الطراز اللبناني، اعتمدت الإيحاء بأنّ مصير الطائفة العلوية ـ بابنائها كافة، عن بكرة أبيهم، بفقرائها ومناضليها الوطنيين الديمقراطيين، وبمعارضيها من نزلاء سجون النظام، في الماضي والحاضر ـ بات مرتبطاً تماماً ونهائياً بمصير النظام. اليوم لم يعد ‘الدرس اللبناني’ مخيفاً في ذاته، لأنّ النظام استبدله بـ’درس سوري’ محلي محض، يقول ببساطة: إمّا استمرار النظام، سواء قبل السوريون ‘الإصلاحات’ الزائفة والتجميلية أو رفضوها، أو الخراب والتقسيم والحروب الأهلية وتدمير الهوية الوطنية. وعلى نحو ما، في ضوء استئناف عمليات الاغتيال في لبنان، بدا وكأنّ النظام السوري انتقل من تخويف السوريين من مصائر لبنان، إلى تخويف اللبنانيين من مصائر سورية!
هذا، بدوره، فائض نقصان لا فائض قيمة؛ وهو خيار انتحاري في الجوهر، ينقل العنف المجّاني من سورية إلى جوارها الإقليمي، ولا يضطر إلى اعتماده إلا نظام يوشك على الانهيار، ولم تتبقّ في جعبته سوى تلك الخيارات التي يرى فيها النظام وحلفاؤه منافذ نجاة أخيرة. ولكنها ما فتئت ترتدّ عليهم، إلى النحور.
بيد أنّ عودة الأذهان إلى مناخات أي من تلك الأطوار لا تعني، بالضرورة، أنّ نفوذ النظام السوري، المباشر والفعلي والمنفرد، قد عاد إليها بدوره، بصفة آلية؛ وإنْ كانت تعني أنّ ‘تلازم المسارات’ بين النظام وحلفائه اللبنانيين، والإقليميين، قد بلغ ذروة قصوى ابتداء من عملية اغتيال الحسن (وهذا نقاش آخر، توقفتُ عند ملابساته قبل أيام، في ضوء منطق أمني وعملياتي وميداني يفرض القاعدة التالية: جميع العمليات التي تجري على الأرض اللبنانية، خدمة للنظام السوري، لا بدّ أن تخضع لترخيص، أو مساعدة، أو حتى توفير أدوات التنفيذ، من جانب ‘حزب الله’ و/أو ‘الحرس الثوري’ الإيراني). ذلك لأنّ نفوذ النظام، اليوم، هو في أضعف حلقاته منذ الدخول العسكري إلى لبنان، صيف 1976؛ وهذا كان النقلة الإقليمية السياسية والعسكرية الأهمّ في تاريخ ‘الحركة التصحيحية’، التسمية الرسمية للانقلاب الذي قاده حافظ الأسد ضدّ رفاقه في حزب البعث منذ أواخر 1969، وتوّجه في 16 تشرين الأوّل (أكتوبر) 1970، حين استكمل وأعلن استيلاءه على السلطة.
ولهذا فإنّ الانسحاب العسكري السوري من لبنان، في شباط (فبراير) 2005، كان قد استكمل تلك النقلة في الوجهة المعاكسة، إذا جاز القول؛ أي في مسار تجريد النظام السوري ـ ببطء تارة، وبتسارع دراماتيكي طوراً، ولكن على نحو مضطرّد إجمالاً ـ من المغانم والأوراق والقوى والحلفاء وهوامش المناورة الإقليمية. ومن الإنصاف القول إنّ انحطاط النفوذ السوري في لبنان كان قد بدأ، سياسياً، في عهد الأسد الأب، مع سحب هذا الملفّ من يد عبد الحليم خدّام، نائب الرئيس آنذاك، وتسليمه إلى بشار الأسد كجزء من ترتيبات إعداد الفتى لخلافة أبيه. (غنيّ عن القول إنّ الانحطاط لم يبدأ لأنّ خدّام كان أرحم باللبنانيين من الأسد الابن، بل على العكس تماماً: الأخير كان في طور التلقين وألعاب الهواة، وكان خدّام أشدّ شراسة وأكثر تشدداً).
غير أنّ الضربة القاصمة جاءت مع وفاة الأسد، حين صحا اللبنانيون على الحقيقة البسيطة التالية: الوجود السوري (‘الشرعي’ و’المؤقت’ بالنسبة إلى الرئيس اللبناني السابق إميل لحود، والمؤقت ولكن اللاشرعي الذي آن أوان إنهائه بالنسبة إلى معظم اللبنانيين) ينبغي أن لا يظلّ على حاله السابقة بعد أن غاب الأسد، صانعه الأوّل، الأعلى دهاء ومكيافيللية ودموية من وريثه في الحكم.
هذه الحقيقة/ البديهة كانت تقبل، أو تصنع تلقائياً، مكمِّلها الاستطرادي، البديهي، الآخر: إذا تآكل الوجود السوري في لبنان ـ سواء نُظر إلى ذلك الوجود في مستوياته العسكرية والسياسية والاقتصادية، أو في امتداداته الأخرى الاجتماعية (العمالة السورية، التوترات بين الشعبين، انقسامات اللبنانيين…)، أو الحقوقية (اتفاق الطائف، القرارات الدولية…) ـ وكفّ عن كونه صانعاً لأوراق القوّة في صفّ النظام؛ فمن المنطقي والحال هذه أن ينقلب إلى عبء على سلطة الوريث، في العلاقة مع الجوار الإقليمي، والعالم بأسره.
ومن الإنصاف التذكير، كذلك، أنّ أولى إشارات الصحو على هذه الحقيقة/ البديهة لم تأت من وليد جنبلاط أو ‘الكتائب’ أو ‘القوّات اللبنانية’، أو أيّ من القوى اليسارية التي سوف تأتلف بعدئذ في إطار ‘اليسار الديمقراطي’؛ وطبيعي أنها أيضاً لم تأت من صفّ رفيق الحريري لأنه كان، آنذاك، أحد أخلص حلفاء النظام السوري. لقد جاءت، ليس دونما مفارقة في واقع الأمر، من مجلس المطارنة الموارنة الذي أصدر بياناً لافتاً تماماً في 20 أيلول (سبتمبر) من العام 2000، أي بعد أشهر معدودات على توريث الأسد الابن، أبدى فيه الحرص على ‘توثيق أحسن علاقات الأخوّة بين لبنان وسورية’؛ ولكنّ المغزى الأهمّ وراء البيان كان التشديد على أنّ الصلة اللبنانية ـ السورية قائمة على ‘علاقات الأخوّة’ وحدها، ليس أكثر!
وإذْ ينصف المرء ذلك البيان اليوم، فليس لأنّ المشهد الراهن يقتضي استذكار تلك الواقعة، والمفارقة خلفها، فحسب؛ بل لأنّ ما انطوى عليه نصّ المطارنة الموارنة كان أقرب إلى استبصار الكثير من التطوّرات التي سيشهدها البلد حين تغادر قوّات النظام السوري. كذلك استدعى، من جانب آخر، جملة استقطابات سياسية واجتماعية ودينية ومذهبية سوف تصبح من جديد جزءاً لا يتجزأ من خطاب، وكوابيس، الحياة اليومية اللبنانية الراهنة. وهكذا، وكما نشهد اليوم مَن يترحّم على الوجود العسكري في صفوف اللبنانيين أنفسهم (وليس عاصم قانصوه وحده، للتذكير، بل الجهة الأخرى الأعلى قبضة وسلاحاً ونفوذاً أمنياً: ‘حزب الله’)، توفّر مَنْ يناهض بيان بكركي في صفوف… مناهضي النظام السوري هذه الأيام! تلك كانت روحية البيان المضاد الذي صدر آنذاك عن ‘اللقاء الإسلامي’، المؤلف من المفتي الشيخ محمد رشيد قباني (ممثلاً لدار الإفتاء السنية)، والشيخ عبد الأمير قبلان (المفتي الجعفري الممتاز)، ومحمد السماك (ممثّل لجنة الحوار الإسلامي ـ المسيحي)، وبهجت غيث (شيخ الطائفة الدرزية).
بيان مجلس المطارنة الموارنة طالب بإعادة انتشار الجيش السوري تمهيداً لانسحابه نهائياً، عملاً بالقرار 520، واستناداً إلى نصوص اتفاق الطائف؛ وبيان ‘اللقاء الإسلامي’ اعتبر أنّ الوجود السوري شرعي ومؤقت كما قال رئيس الجمهورية، وأي موقف منه تقرره السلطات الرسمية. موقفان، إذاً، على طرفَي نقيض وعلى طرفَي استقطاب ديني واضح: مسيحي/مسلم. إلى هذا، كان الفارق بين البيانين لا يقتصر على انقسام حادّ بين ‘لا’ و’نعم’ للوجود السوري، بل تجاوز اللونَين الأبيض والأسود إلى تدرّجات للرمادي، عديدة ومعقدة! بين هذه التدرّجات، العابرة للدينيّ والمذهبيّ والسياسي بمعنى السياسة الصرفة الكلاسيكية، ما جاء في بيان مجلس الوزراء اللبناني ردّاً على بيان المطارنة الموارنة: ‘العلاقات بين سورية ولبنان ليست أمراً مزاجياً يتغير بتغيير المواقف الخارجية والفئوية، بل هي علاقة ستراتيجية تحددها الدولة بمؤسساتها الدستورية، وأنّ هذه العلاقة هي من الثوابت التي تقوم على تأكيد مصلحة لبنان أولاً، والتي تؤكد أيضاً ثبات المواقف القومية مع الشقيقة سورية وأواصر المصالح المشتركة في ما بيننا’.
بالطبع، المعادلات اختلفت جذرياً بعد اغتيال الحريري الأب، وانقلاب سواد السنّة على دمشق، وانحياز سواد الدروز إلى وليد جنبلاط بوصفه ممثّل الزعامة التاريخية على الأقلّ، حين انخرطت دمشق في تأثيمه وتجريمه. وباتت أشباح الحرب الأهلية أقلّ هيمنة على الوجدان الشعبي العامّ، بل صار من المشروع القول إنّ خريطة الولاءات المذهبية ذات التلوّن السياسي (بصدد الموقف من النظام السوري، أساساً) أقلّ تعقيداً من ذي قبل، وبالتالي أوضح في الطبيعة والتكوين والقدرة، وأيسر سيطرة في حال اندلاع صدامات مذهبية أهلية. لكنّ الحال تغيرت في الصفّ المسيحي أيضاً، والماروني منه بصفة خاصة، وكان انتساب ميشيل عون إلى نادي حلفاء النظام السوري يعيد خلط الأوراق على نحو ينتهي إلى ترسيخ ذلك الإجماع اللبناني على مبدأ كلاسيكي في المحاصصة: لا غالب ولا مغلوب!
ورغم تبدّل المواقع بين الأغلبية والمعارضة، وبين حكومة سعد الحريري وحكومة نجيب ميقاتي، زار الأخيران دمشق مثلما زارها وليد جنبلاط وحسن نصر الله؛ ولكن، في غمرة التقلبات كافة، ظلّ ميزان نفوذ النظام السوري يشير إلى فائض نقصان، وليس فائض قيمة؛ وإذا ما قيس بمعدّلات الأحقاب ‘الذهبية’، حتى أواخر التسعينيات، فإنّ النفوذ كان في حال من تآكل مضطرد. الانتفاضة السورية أكملت هذه السيرورة، بمعنى أنها شدّدت وتائر التآكل، من جهة أولى؛ وأوقعت حلفاء دمشق في حرج الاصطفاف خلف النظام رغم الأكلاف السياسية والأخلاقية الهائلة وراء اضطرار كهذا، من جهة ثانية. وفي الخلفية الأخرى، السياسية ـ الاجتماعية لواقع المحاصصة، أثبتت الانتخابات النيابية الأخيرة أنّ الميول الشعبية العامة على حالها تقريباً عند الطوائف المسلمة، فصوّتت كلّ طائفة لمرشحيها: السنّة بنسبة تجاوزت 88 بالمئة، والشيعة 90 بالمئة، والدروز 92 بالمئة. ولكنّ الميول كشفت، في الآن ذاته، عن انقسام في صفوف المجموعات المسيحية المتنازعة، بحيث آل إلى السنة والدروز أمر ترجيح فريقَيْ ‘الكتائب’ و’القوات اللبنانية’، حلفاء 14 آذار؛ وتولى الشيعة دعم مرشحي الجنرال عون، المسيحيين.
ولقد انصرم زمن شهد تطبيق النظام السوري ستراتيجية تخويف المجتمع السوري من أخطار حرب أهلية على الطراز اللبناني، اعتمدت الإيحاء بأنّ مصير الطائفة العلوية ـ بابنائها كافة، عن بكرة أبيهم، بفقرائها ومناضليها الوطنيين الديمقراطيين، وبمعارضيها من نزلاء سجون النظام، في الماضي والحاضر ـ بات مرتبطاً تماماً ونهائياً بمصير النظام. اليوم لم يعد ‘الدرس اللبناني’ مخيفاً في ذاته، لأنّ النظام استبدله بـ’درس سوري’ محلي محض، يقول ببساطة: إمّا استمرار النظام، سواء قبل السوريون ‘الإصلاحات’ الزائفة والتجميلية أو رفضوها، أو الخراب والتقسيم والحروب الأهلية وتدمير الهوية الوطنية. وعلى نحو ما، في ضوء استئناف عمليات الاغتيال في لبنان، بدا وكأنّ النظام السوري انتقل من تخويف السوريين من مصائر لبنان، إلى تخويف اللبنانيين من مصائر سورية!
هذا، بدوره، فائض نقصان لا فائض قيمة؛ وهو خيار انتحاري في الجوهر، ينقل العنف المجّاني من سورية إلى جوارها الإقليمي، ولا يضطر إلى اعتماده إلا نظام يوشك على الانهيار، ولم تتبقّ في جعبته سوى تلك الخيارات التي يرى فيها النظام وحلفاؤه منافذ نجاة أخيرة. ولكنها ما فتئت ترتدّ عليهم، إلى النحور.
‘ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس


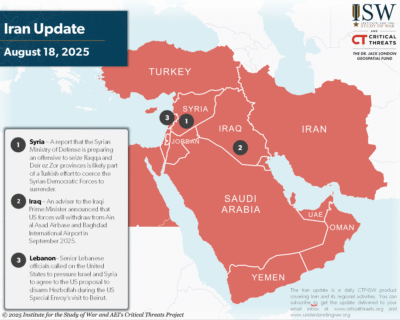

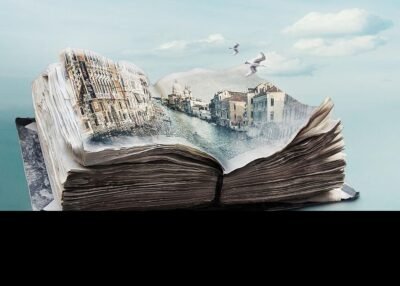
More Stories
البيان المشترك حول السويداء: أثر الإخفاقات الحكومية على تدويل الملف
ازدهار الرجعيات السياسية: الثورة على قيم الزيف المعاصر.
الغياب القطري عن المشهد السوري: ماذا يحدث وراء الكواليس؟