رفض رئيس الوزراء التركي، رجب طيب أردوغان، الجمعة، الاكتفاء بعملية عسكرية محدودة ضد سوريا المتهمة بشن هجوم كيماوي على مدنيين من سكانها، معتبرا أن أي تدخل ينبغي أن يهدف إلى إسقاط النظام في هذا البلد.
وصرح أردوغان للصحافيين، كما نقلت عنه قناة “أن تي في” الإخبارية، بأن “عملية محدودة لن ترضينا”.
وأضاف “ينبغي القيام بتدخل كما حصل في كوسوفو، لأن تدخلاً ليوم أو يومين لن يكون كافياً، ويجب أن يكون الهدف إجبار النظام على ترك السلطة”.
وأعلن الرئيس الأميركي باراك اوباما أنه لم يتخذ بعد “قرارا نهائيا” بشأن سوريا، لكنه تحدث عن عملية أميركية “محدودة” لمعاقبة النظام السوري المتهم باستخدام أسلحة كيماوية في هجوم أودى، بحسب الاستخبارات الأميركية، بحياة 1429 شخصا في 21 أغسطس/آب قرب دمشق.
Opinion Activists




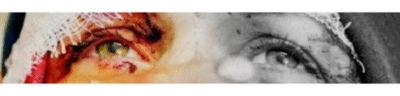

More Stories
البيان المشترك حول السويداء: أثر الإخفاقات الحكومية على تدويل الملف
ازدهار الرجعيات السياسية: الثورة على قيم الزيف المعاصر.
الغياب القطري عن المشهد السوري: ماذا يحدث وراء الكواليس؟