 في 18 مارس/آذار 2011، خرج أكثر من 2000 مواطن ومواطنة في تظاهرة مدينة درعا، عروس الجنوب، وقد تم التعرض للمتظاهرين بالرصاص الحي وخراطيم المياه وسيارات إطفاء وهراوات، وسقط أربعة شهداء وعشرات الجرحى، إضافة لاعتقالات جماعية ودخول لوحدة عسكرية لشمال المدينة ونزول طائرات مروحية في ملعبها الرياضي.
في 18 مارس/آذار 2011، خرج أكثر من 2000 مواطن ومواطنة في تظاهرة مدينة درعا، عروس الجنوب، وقد تم التعرض للمتظاهرين بالرصاص الحي وخراطيم المياه وسيارات إطفاء وهراوات، وسقط أربعة شهداء وعشرات الجرحى، إضافة لاعتقالات جماعية ودخول لوحدة عسكرية لشمال المدينة ونزول طائرات مروحية في ملعبها الرياضي.
هل أخذت درعا مكانها بوصفها سيدي بوزيد التغيير الديمقراطي في سوريا؟ وهل دشنت الحركات العفوية ذات الخط المتصاعد في البلاد ربيعا جديدا لسوريا؟
لقد جاء تحرك درعا، رغم كل الاستنفار والاحتياطات الأمنية التي جرت للحؤول دونه، ليؤكد أن سوريا ليست خارج المكان والزمان والتاريخ.
حتى مساء 17 مارس/آذار، لم يكن بالإمكان الحديث عن آلاف بل عشرات، ولكنهم حملوا بذور لقاح التغيير، كونهم أمسكوا بالوصلة الجامعة للسوريين: “لا سنية ولا علوية، حرية وديمقراطية”، “لا للفساد”، “يسقط سجان الشعب”، “يا حرية يا حرية تعالي من مصر لسورية”.
لقد تواعد عدد غير قليل من شباب ولد في ظل حالة الطوارئ وفرضت عليه صيغ انتساب شبه إلزامية لمنظمات لم يعد لها القدرة على أي فعل سياسي أو مدني، بل حتى إداري، وجرت محاسبته على كل همسة وجلسة، وملاحقته على كل كلمة وبسمة، حتى أصبح في سماته الأساسية شبابا يحمل براغماتية الشياب، مع طموح تكبله أجهزة عمت بسرطانيتها كل منزل ومجلس.
أغلقت كل المنتديات، ولم يكن ثمة حق في التجمع أو التجمهر إلا في المساجد والمباريات الرياضية، انخفض سقف المطالب ولم تستطع حقبة البؤس التي خلقتها الحرب على الإرهاب والاحتلال الأميركي للعراق، إلا أن تعزز مبدأ “دعنا بما نعرف وأبعد عنا مجاهيل ما لا نعرف”.
لكن العوامل نفسها التي أبرزت بشاعة أنموذج التغيير في دبابة المحتل، وعولمة حالة الطوارئ، وصيرورة الأمن الإسرائيلي للقوى الغربية “الديمقراطية” القضية المركزية الأولى، واستهداف سوريا، كل سوريا سلطة وشعبا، لأنها احتضنت مكاتب المقاومة الفلسطينية، وأقام نظامها تحالفا إستراتيجيا مع حزب الله.
هذه العوامل التي زعزت تعبيرات المعارضة التاريخية وخلقت في صفوفها انقسامات وشروخا عميقة، هي التي تشكل اليوم المشروعية الفعلية لشباب لم يفقد يوما البوصلة الوطنية، والتحم بعمق في كل نشاطاته مع المجتمع الفلسطيني في سوريا، وامتلك وضوح رؤية حول تحرير الجولان يتقدم فيه على الجبهة الحاكمة نفسها
هذا الشباب، الذي استقبل النازحين اللبنانيين أثناء العدوان على لبنان في 2006 وعبر عن وحدويته بالتضامن مع أكثر من 1.5 مليون عراقي كانوا ضحية الاحتلال وعقابيله، وجمع التبرعات مع الشعب الفلسطيني في غزة، كان أول من تلقف صوت الثورة من سيدي بوزيد والقصرين، ومن تابع شباب مصر في ساحة التحرير، ووقف ليقول بكل قوة للسلطة التسلطية في البلاد “نحن الممثل الشرعي للثورة العربية بكل أبعادها، نحن من يمثل المدنية لأننا رفضنا كل الأشكال العضوية التي اتكأت عليها السلطة وبعض تعبيرات المعارضة، نحن من يرفض العصبيات القديمة الممزقة للنسيج الوطني، نحن من يرفض أي استعمال للعنف لأننا الضحية الأولى لكل أشكال العنف السلطوية. ونحن من يبني الأنموذج القادر على استعادة حقنا في الحلم”.
لكن اللوحة ليست دائما بهذا الجمال، فقد احتفلت السلطة بحياء بالذكرى الـ48 للثامن من آذار، انقلابا عسكريا جرى تعميده ثورة، وخرجت كل جروح المجتمع الذي يختصر هذا التاريخ بإعلان حالة الطوارئ وعملية مصادرة بدايات دولة قانون ومؤسسات انطلقت في 1954-1958. فلم تجد حرجا في الاستمرار بكل العفش التسلطي الذي راكمته الأيام والسنين.
بل وبعد اعتقالات شبه يومية لمناضلات ومناضلين من عدة تيارات، منذ انطلاقة الثورة التونسية، لم يتسع “العفو” الرئاسي لأكثر من سجين واحد هو المحامي هيثم المالح، بداعي العمر لا برغبة الإفراج عن المعتقلين. ولم يكن لمعتقلي الرأي إلا الإعلان عن إضراب مفتوح من أجل الحرية في هذا التاريخ نفسه من سجن درعا.
لم تنجح أشكال المعارضة التقليدية بعد في تجاوز خطاب لم يعد مصدر استقطاب للجيل الجديد، كذلك تحمل معارضة الخارج كل الطحالب والعقابيل التي ينتجها الحرمان من العلاقة المباشرة بالمجتمع، فهي تعيش المجتمع الافتراضي مرتين، مرة في الشبكة الاجتماعية العنكبوتية، ومرة في المجتمع التخيلي الذي بنته عن سوريا لم تعرفها في يوم من الأيام.
فالمأساة السورية تفتح دائما جراح أكثر من ثلاثين ألف منفيٍ قسري لأسباب سياسية مباشرة يجاوز عددهم مع عائلاتهم المائة ألف، وأبناء هؤلاء وأحفادهم هم الذين يتحدثون عن الشوق إلى سوريا وعن التغيير الموجه من الخارج بخطاب لا يجد بالضرورة من يفهمه داخل البلاد التي حرم منها جيلان أحيانا ولا يعرفها إلا عبر روايات الأهل.
فهؤلاء كانوا أولا ضحايا سنوات العنف 1978-1982 بين الطليعة المقاتلة والسلطة، وثانيا ضحايا التهميش والاضطهاد بحق الأكراد الذي خلق دياسبورا كردية كبيرة ومسيسة. وأغلبية الشباب السوري لا تتعرف على نفسها لا في الخطاب الانتقامي لبعض الإسلاميين، أو في الخطاب الشوفيني لبعض القوى الكردية. وتعد هذا خطرا على الوحدة الوطنية ووحدة البلاد.
من هنا الفارق بين خطاب التجمعات الجديدة داخل البلاد مثل “حركة شباب 17 نيسان للتغيير الديمقراطي” ومبادرات فيسبوكية من واشنطن ولندن وباريس … إلخ، تعتقد، مثلما روج بعض أشباه المثقفين-الصحفيين في الغربـ أن فيسبوك والأنموذج الإسرائيلي والفضائيات هي التي صنعت البيئة الثورية العربية الراهنة.
تحاول أنظمة الدكتاتورية العربية كافة أن تصور التغيير الحاصل في بعض البلدان العربية اليوم باعتباره في أحسن الأحوال غير ذي جدوى، وفي أسوأ الأحوال فتنة لتمزيق العباد والبلاد وبث الشر والخراب.
ولعل “كتائب القذافي” اليوم المعقل الأخير لهذه الأطروحات، عبر نقل الأنموذج الثوري المصري-التونسي للتغيير من ثلاثية (المدنية، السلمية، الوحدة المواطنية) ورباعية (العدالة، الحرية، المساواة، الكرامة) إلى الصراع الدموي زنقة زنقة، واستباحة المدنيين وقصف المدن والموارد الحيوية واعتبار المواجهة العسكرية للثوار، سيناريو مقبولا ومعقولا للتعامل مع الحالة الثورية العربية (للأسف المأساة الليبية تتكرر في البحرين ملبسة بثوب الخطر الخارجي والمشروع المذهبي!). وتروج أجهزة السلطة في سوريا لهذا الخطاب أيضا.
لكن كيف يمكن الوثوق بمن يقتل شعبه للاحتفاظ بالسلطة بأي ثمن؟ وهل يمكن الركون لمن مارس الاستبداد وسرق المال العام أو تواطأ معهم وآزرهم بالقلم وعلى المنابر، إعلامية كانت أم دينية، لمجرد أنه يلوح باستعمال العنف الصلف مع المجتمع؟
إن صيرورة الوضع الثوري عربيا لا تنبع فقط من الاشتراك في الثقافة واللغة والآمال والآلام في عالمنا العربي بين كل المكونات عربية وأمازيغية وكردية … إلخ، بل أيضا وقبل كل شيء في كوننا جميعا ضحايا منظومة دكتاتورية واحدة نكتشفها كلما نزل الشعب إلى الشارع في عاصمة جديدة فلا يسعنا إلا أن نقول: حسبك فقط أن تغير الاسم، أليست هذه قصتك أنت .
فعلى خلاف طبيعة السلطات وتكوينها ووسيلة الاستمرار، سعودية كانت أم قذافية، مباركية أم بعثية، ملكية أم جملكية، توجد منظومة تسلطية عربية للحكم مشتركة في مواصفات رئيسية يمكن تلخيصها بالتالي: تأميم السلطة التنفيذية للفضاءين العام والخاص والسلطات التشريعية والقضائية والرابعة، اعتبار المال العام مزرعة خاصة لبطانة الحاكم، رفض فكرة وحقوق المواطنة، ربط الدفاع عن حقوق الناس بالخارج والغرب والمؤامرة، التعامل الأمني في كل القضايا السياسية والمدنية، فرض سياسات اقتصادية واجتماعية من فوق يتخللها مكارم للحكام من وقت لآخر لا تغني عن فقر ولا تستجيب لحاجات التنمية، تجهيل المجتمع، اختزال مفهوم السيادة في طمأنة القوى الكبرى بأن مصالحها ومطالبها في قمة أجندة قمة السلطة.
أمام هذه الصورة القاتمة، ومهما حدث واستشرست قوى النظام القديم كما يحدث في ليبيا اليوم، لن يكون المستقبل إلا أحسن مما كان، وبالتالي كل من يحدثنا عن مخاوف الفراغ والانقطاع والفوضى … إلخ يستحضر موضوعة العبد الخائف من حريته.
لقد اقتنعت الشبيبة في العالم العربي بأنه لا شيء في ميراث الدكتاتورية العربية نبكي عليه. في حين تحمل ثورات الشباب في العالم العربي للبشرية صفحة عظيمة جديدة، فمقاومتها مدنية، ووسائل نضالها سلمية، وقد تحررت من الحزبية الضيقة والأيديولوجية المقيدة، وهي تؤكد على هويتها الحضارية المدنية وضرورة تأصيل الديمقراطية وتوظيف كل خيرات البلاد لأهلها وليس لعصابات السراق فيها. بحيث تتكون معالم المستقبل الجديد بشكل جماعي ومن كل الطاقات دون استثناء أو استقصاء أو تهميش أو تمييز.
لقد وضعت الثورة التونسية وبعدها المصرية حدا لحالة الربط العضوي في الذاكرة الإنسانية بين الثورات والقتل دفاعا عن النفس أو انتقاما ممن أذل وقتل، بحقنها دماء الجميع واعتبارها العدل معيارا للتعامل مع الماضي وليس الثأر.
وحدها أجهزة النظام الدكتاتوري القديم كانت تمارس البلطجة والقتل وتوظف المرتزقة، والمثل الليبي أبلغ تعبير عن وحشية الحاكم وجاهزيته لكل الجرائم من أجل الاحتفاظ بالسلطة.
وقد التقط الشباب في سوريا هذه الرسالة البناءة للتغيير التي جعلت من الشرعية الشعبية أرقى وأعلى أشكال الشرعية، بل القراءة الوحيدة لتفعيل المقاومتين المدنية والوطنية .
لقد وقفت القطاعات الأوسع من الشباب السوري نصيرة ومتابعة للتغيير في مصر وتونس، واستنكر المجتمع السوري بكل أطيافه الموقف الرسمي المخجل من نظام القذافي، بل وعبر عدد كبير من المواطنات والمواطنين عن ذلك برغبتهم في الالتحاق كممرضين وأطباء بمدينة بنغازي أو المشاركة في التحقيق في الجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها.
وكان تاريخ سقوط الفرعون نقطة مفصلية في الخطاب الديمقراطي الوطني، حيث ثمة وعي بأن الأرض العربية كلها أصبحت الملجأ والمنطلق للمقاومة الفلسطينية وليس فقط سوريا.
كل هذه المستجدات، كان في مقابلها تكلس سياسي ومسلكي عند السلطات السورية التي ترفض استيعاب ما يجري من تغييرات حولها وداخل حدودها، وتعتقد أن زيادة وتيرة الرقابة والاعتقالات كفيلة بضبط الوضع المجتمعي السوري.
وقد تجلى ذلك بوضوح في 15-16 مارس/آذار الحالي، حيث شملت الاعتقالات أكثر من 30 شخصية مدنية وسياسية في تحركين، الأول من أجل التغيير الديمقراطي والثاني تضامنا مع معتقلي الرأي. لكن هل ثمة قراءة لما يحدث، غير استعمال السلطات السورية لأسلحة فاشلة تنتمي لحقبة انقرضت؟
لا يمكن بحال الهرب من لحظة الحقيقة، فبالأمس وقف المجتمع السوري مع ذكرى حالة الطوارئ المدمنة المزمنة، وغدا ذكرى استقلال لم يبق للمواطنة فيه مكان، وبعد غد انتخابات مجلس شعب لا يحمل من الشعب إلا الاسم والرائحة، وبعده استفتاء رئاسي على شخص واحد مرشح من حزب واحد، وكل هذا في ظل دستور قرونوسطي تعطله حالة الطوارئ، رغم تنصيبه حزب البعث قائدا للدولة والمجتمع.
كل هذه البؤر التسلطية التي رحلت عن كوكب الأرض منذ دهر، ولم يعد يشاطرنا بها سوى نظام كوريا الشمالية، هل ستقوى على مواجهة رياح الثورة؟
من دمشق جاء الجواب على لسان “حركة شباب 17 نيسان للتغيير الديمقراطي”: إذا لم تغيّر.. بالضرورة ستتغير”.


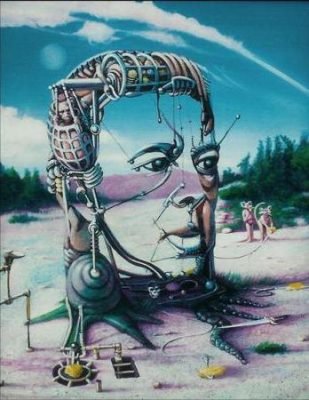


المزيد من المواضيع
تحول تاريخي: الاعتراف الرسمي بحقوق الكرد السوريين وإعادة تعريف الشراكة الوطنية
حين يصبح السلاح عبئاً على الأكراد… حلّ قسد لم يعد خياراً
هل تُهدّد الترتيبات الأمنية مكانة الجولان كأرض سورية محتلة؟