ياسين الحاج صالح : المبعوثون والممثلون الدوليون وما شابه
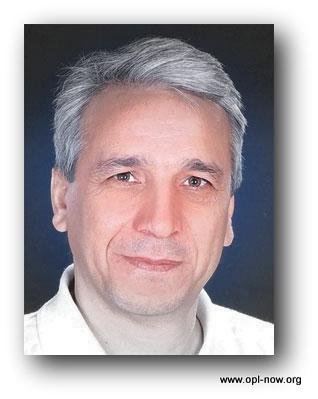 هناك فئة واسعة من الموظفين الدوليين، الغربيين أساسا، المعنيين اليوم بالقضية السورية، وبالأمس واليوم بالقضية الفلسطينية، يمثلون هيئات «أممية»، أو بلدانهم النافذة. وحين لا يكون الواحد منهم شخصيا من صناع القرار في شأن قضايانا، فإنه يتحرك في دوائر صناع القرار في بلده وفي الهيئات الدولية، وله بالقطع تأثير على القرارت التي تمس مصائرنا، بلدانا ومجتمعات وأفرادا. فما هو تكوين هذه الفئة المخصوصة، الخطيرة الشأن؟ ماذا يشبه أولئك الرجال الذين تكلفهم بلدانهم الغربية أو الأمم المتحدة بمتابعة قضية سوريا أو فلسطين أو ليبيا أو اليمن أو السودان أو الصومال أو أفغانستان؟ بحدود ما أعلم ليست هناك كتابات بالعربية عن الأمر، ولست مطلعا على كتابات محتملة عنهم بالانكليزية. هذه المقالة تستند إلى معرفة شخصية ببعض العاملين في هذه الدوائر، وإلى متابعة لبعض تصريحاتهم وكتاباتهم.
هناك فئة واسعة من الموظفين الدوليين، الغربيين أساسا، المعنيين اليوم بالقضية السورية، وبالأمس واليوم بالقضية الفلسطينية، يمثلون هيئات «أممية»، أو بلدانهم النافذة. وحين لا يكون الواحد منهم شخصيا من صناع القرار في شأن قضايانا، فإنه يتحرك في دوائر صناع القرار في بلده وفي الهيئات الدولية، وله بالقطع تأثير على القرارت التي تمس مصائرنا، بلدانا ومجتمعات وأفرادا. فما هو تكوين هذه الفئة المخصوصة، الخطيرة الشأن؟ ماذا يشبه أولئك الرجال الذين تكلفهم بلدانهم الغربية أو الأمم المتحدة بمتابعة قضية سوريا أو فلسطين أو ليبيا أو اليمن أو السودان أو الصومال أو أفغانستان؟ بحدود ما أعلم ليست هناك كتابات بالعربية عن الأمر، ولست مطلعا على كتابات محتملة عنهم بالانكليزية. هذه المقالة تستند إلى معرفة شخصية ببعض العاملين في هذه الدوائر، وإلى متابعة لبعض تصريحاتهم وكتاباتهم.
يتعلق الأمر برجال غالبا، وبنساء أقل، من الشرائح العليا من الطبقة الوسطى أو من الطبقة العليا في بلدانهم، درسوا في جامعات من الأفضل في العالم، رواتبهم عالية، يسافرون كثيرا، ويلتقون في بلداننا برؤساء وملوك ووزراء وسفراء. وهم يتقلبون في مناصب تتراوح بين السفير والوزير والمبعوث الخاص والمستشار في «مركز دراسات استراتيجية» مرموق. ومن يكن سفيرا منهم يقيم في بيت فخم في الأحياء الدبلوماسية، أما المبعوثون فيقضون أوقاتهم خارج العمل في فنادق ومطاعم «راقية»، في صحبة مرافقين من نخبة البلد الذي يزورونه، أو دبلوماسيي بلدهم، أو النخبة الدبلوماسية الغربية في البلد المعني.
ينحدر معظم هؤلاء البيروقراطيين الدوليين من الغرب، المنطقة الأغنى في العالم، الأقوى عسكريا، الأقوى تأثيرا عالميا، والتي لم تعان منذ سبعين عاما من مآس عامة كبيرة سببها إنساني. ومعظم سياسيي اليوم في الغرب ولدوا بعد الحرب العالمية الثانية، فلا هم سليلو صراعات اجتماعية أو حروب كبرى، ولا هم خبروا في حياتهم الخاصة والعامة مآس يمكن مقارنتها بما حصل لأكثر بلدان العالم الأخرى، ومن هذه الأخيرة ما أوقعتها بها بلدان المبعوثين والممثلين. يحصل أن يكون بينهم من ليسوا غربيي المنبت، مثل كوفي أنان والأخضر الإبراهيمي بخصوص «الأزمة السورية»، لكنهم بيروقراطيون دوليون، يتبنون اللغة المعقمة للمنظمات الدولية، بحيادها القيمي الزائف، ويحولون الصراعات الاجتماعية والسياسية الكبيرة إلى «أزمات» تعالج بمنهج «إدارة الأزمات» الذي ينزع الصفة السياسية عما هي قضايا سياسية جوهريا. وبحكم تكوينهم في دول «متقدمة»، منظمة، ومستقرة، يُعتقد على نطاق واسع أنها نموذج ريادي للعالم ككل، منظورات المبعوثين والممثلين دولتية جدا، متمركزة حول الدولة، ومنحازة لكل ما هو دولة ومنظم ومركز. هذا في الغرب نفسه أولا، حيث الدولة- الأمة أهم اختراعات الحداثة وضمانتها في الوقت نفسه.
وليس هذا التكوين مقصورا على الممثلين والمبعوثين الدوليين وكبار العاملين في مؤسسات بحثية غربية ودولية تعنى بشؤون «الشرق الأوسط»، بل هو كذلك تكوين النخب السياسية الغربية عموما في زمن ما بعد الحرب الباردة. كانت هذه النخب قد طورت في زمن الحرب الباردة، وكضرب من التطعيم ضد الشيوعية السوفييتية ومشتقاتها، إيديولوجية ومؤسسات دولة الضمان الاجتماعي التي توسع نطاق الديمقراطية ليشمل شرائح أدنى من المجتمع. وهو ما أسبغ على فكر النخب الغربية عناصر إيديولوجية وقيمية عامة، لا تقتصر على «الحداثة» و»العقلانية».
مع نهاية الحرب الباردة قبل ربع قرن، لم تعد هناك وجهة عالمية ولا رؤية عالمية لسياسات النخب الغربية التي تطورت في اتجاه أكثر بيروقراطية وفنية وإدارية، وأقل سياسية. وهذا مع بقائها، تلك النخب، في موقع لا منافس له عالميا في التأثير على مصائر بلدان وشعوب كثيرة، والكوكب بملياراته السبعة.
وفيما يخص منطقتنا لدى تلك النخب ما يتراوح بين النفور والعداء حيال الإسلاميين، والمودة والحب الشديد لإسرائيل. وهي في كل حال لا تعرف جديا من مجتمعاتنا غير حكام كانوا يخنقون محكوميهم ويعزلونهم عن العالم. مجتمعاتنا، في عين المبعوث والممثل الدولي، مكونة من هلام لا ملامح واضحة له، ومن ملامح واضحة جدا لأشخاص مثل بشار الأسد وحسني مبارك وملوك الخليج وأمرائه، ومن شابههم. وهو ما تفاقمه المهنة الدبلوماسية المتمركزة تكوينيا حول الدولة، ثم أولوية الشواغل الجيوسياسية والجيوستراتيجية في تكوين المبعوثين والممثلين والباحثين في شؤون الشرق الأوسط. والاستراتيجيا «علم» يستخلص توجهات سياسية ضرورية، يمكن أن تترتب عليها عواقب وخيمة، من مقدمات اعتباطية جدا، تتمثل أساسا في مفهومي الهوية القومية والمصلحة القومية (تختلط حتى في «الديمقراطيات» الغربية بمصالح الفريق الحاكم، الحزبية والشخصية). الاستراتيجيا لا ترى مجتمعات ولا ترى صراعات اجتماعية، ترى دولا ولاعبين سياسيين كبارا فقط.
على أن المبعوثين يعرفون جيدا جدا، والحق يقال، أن بلداننا مكونة من مسلمين وغير مسلمين، ولديهم انجذاب غريزي قوي تجاه الشؤون الدينية والإثنية، موروث من أيام الاستشراق والاستعمار. في بلدان مثل سوريا ولبنان والعراق، يعرف الدبلوماسي الغربي والمبعوث الغربي والباحث الغربي في مركز دراسات من نوع «المجموعة الدولية لمقاربة الأزمات»، أشياء كثيرة عن المسلمين والمسيحيين، وعن العلويين والسنيين، وعن الكرد والعرب، ولديهم في هذه الشؤون تفاصيل ومعطيات يتواتر أن لا نملك نحن أهل البلد مثلها.
في المحصلة، الرجل مبرمج على ترجمة المآسي الإنسانية إلى اللغة الباردة للبيروقراطية الدولية، وهو لا يكف عن محاولة معالجة الصراعات الاجتماعية والسياسية الكبيرة باقتراح حلول وسط فنية، لا تترك مجالا لقضايا العدالة، ولا تؤسس لأوضاع اجتماعية وسياسية وقانونية أفضل على مدى أبعد. المدى الأبعد لا يهم منهج إدارة الأزمات على كل حال. وكلما كان هناك طرف مركزي منظم أشد إجراما كانت الحلول الوسط المقترحة أنسب له وأقرب إلى موقعه. الضعيف خاسر منهجيا ودوما من هذا المنهج السياسي. فرص بشار الأسد السياسية بعد أن قتل ربع مليون صارت أفضل من فرصه حين كان قد قتل 10 آلاف فحسب.
هذا المنهج الإداري التسييري معاد للديمقراطية في كل مكان، بما في ذلك في المراكز الغربية. وهو متولد في تقديري عن تحولات سياسية ومؤسسية في الغرب إثر انتصاره في الحرب الباردة، تحولات تستتبع السياسة للاقتصاد وترجح نموذج الشركة الخاصة بعيدا عن الدولة الاجتماعية العامة في صيغة اشتراكية ديمقراطية أو في صيغة كِنزية.
لا يزال الغرب «ديمقراطيا»، لكن ظهر أنه ليس قوة دمقرطة عالمية اليوم، وأنه يفتقر أكثر وأكثر إلى طاقة كامنة تحررية. وهو متقدم، لكنه ليس قوة تقدم عالمية، ولا كمون تقدميا لديه. إنه منطقة ممتازة في العالم وحريصة جدا على امتيازاتها، وتقاوم المساواة بكل قواها. إن لم تجر معاكستها بقوة، يرجح لهذه التحولات أن تؤدي إلى ضمور الديمقراطية في الغرب ذاته، وإلى تحجر التقدم في صورة أرستقراطية ممتازة مسلحة، في استنفار دائم ضد برابرة مهددين.
طوال عقود، كان لقاء بنية المصالح الغربية في منطقتنا الشرق أوسطية مع التكوين الدولتي للمبعوثين الغربيين والدوليين، ومع وضع امتيازي محافظ للغرب في العالم، يدفع إلى الصدارة قضية الاستقرار. وهو ما يضمنه الشيء الذي يسمى «الدولة»، ويغلب ألا يتجاوز معناها جهازا منظما قادرا على القتل، يقوم عليه رجال يرتدون ربطات عنق.
والخلاصة أنه يلتقي في تكوين المبعوث الدولي منزع دولاني مع ضمور متفاقم للعنصر القيمي والسياسي في تصور العالم لمصلحة الاعتبارات الفنية والإجرائية (ومع أرجحية الحداثة في تصور العالم على حساب العدالة، والعقلانية على حساب التحرر)، ومع انتمائه إلى شرائح ممتازة في بلدان تشكل الشريحة الممتازة في العالم. وبفعل هذا التكوين، المبعوث لا يحس حتى حين يعرف، والقليل الذي يعرفه منزه عن الإحساس.
نقد المبعوثين مقدمة ضرورية لنزع هيمنة تصوراتهم عن العالم، وللإمساك الفكري والسياسي بقضايانا. اليوم يرتضي المبعوثون لنا ما لا يرتضونه لبلدانهم، وهو ما يكفي للقول إنهم ليسوا فاعلين أخلاقيين، وما يسوغ الاعتقاد بأن ما يعدونه لنا هو «سلام لا سلام بعده»، على ما عَنْوَن ديفيد فرومكين كتابا له عن تكوين الشرق الأوسط المعاصر، صدر عام 1989.
طبيب و كاتب سوري – المقال نقلا عن القدس العربي





