رغم الصداقة المديدة التي جمعت عائلتينا، لم ألتقِ ابن العم شخصياً إلا غداة الإفراج عنه في العام 1998، بعد 18 عاماً أمضاها في زنزانة انفرادية في قبو المخابرات العسكرية. قبل ذلك التاريخ، كان اسم رياض الترك يتردد همساً على مسامعنا، كتجسيد للاعتقال التعسفي والصمود المديد، نحن مواطنو مملكة الرعب والصمت، مملكة حافظ الأسد.
كان رياض الترك قد تكرَّسَ لجيلنا الشاب رمزاً للطريق الديمقراطي الممكن، بين مشروع الدولة الإسلامية الصاعد من جهة وبين دولة الأسد الديكتاتورية في الجهة المقابلة.
منذ اللقاء الأول، وعلى مدى ربع قرن، لم تنقطع علاقتنا ولقاءاتنا و«زعبراتنا» كما كان يُسميها. عرفتُ في ابن العم معنى الشجاعة، وأَعدتُ من خلاله اكتشاف عالم السجون الذي لطالما شغلني كابن معتقل سياسي حرمه حافظ الأسد أن يعيش حرية أبيه.
بعد ثلاثة شهور من إطلاق سراحه، رفض ابن العم الإدلاء بأي تصريح سياسي لجريدة لوموند التي زارته بتاريخ 30 آب (أغسطس) 1998، وطلب إمهاله بعض الوقت، وقال: «أتكلّمُ كالطفل الذي يبدأ باكتشاف العالم، والعالم تغيَّرَ كثيراً. الوضع الحالي، لم أفهمه بعد كفاية. لكن ما يصدمني أنني أجد المجتمع صامتاً».
عندما تم إخبارُه بقرار الإفراج عنه، طلبَ رياض الترك إبقاءَه ليلة إضافية في السجن ليتحضّر بهدوء للخروج، ويوضّب أغراضه الشخصية التي جمعها في زنزانته. لم يكن رياض الترك متسرّعاً في الخروج من عالمه السفلي إلى العالم الخارجي! كان يعرف ما ينتظره، وكان قد أعدّ نفسه بعناية لاستئناف معركته في مقارعة الاستبداد في حال تم إطلاق سراحه. لا بل إنه نَهَرَ مدير فرع فلسطين العميد كمال يوسف، عندما لم يحترم رغبته وسمح لعائلته أن تأتي للسجن لمواكبته إلى حمص في الليلة ذاتها، بدل الانتظار إلى اليوم التالي.
على مدى أكثر من عام، أعاد ابن العم التعرُّفَ على الحياة تحت سماء المملكة الأسدية بعد أن عاش 18 عاماً في باطنها. كان حافظ الأسد في خريف حياته وذروة سطوته، وكان مشروع التوريث يمضي قدماً. يومذاك لم يكن مُتاحاً رفع الصوت علناً في سوريا للمطالبة بالتغيير الديمقراطي، ولم يكن هناك بعدُ بيانات ولا منتديات، وكان البعض من المعارضين بالكاد يتحدث عن الإصلاح تحت ظلال الخيمة الرئاسية.
وافقَ ابن العم نهاية العام 1999 على إعطائي أول مقابلة سياسية له بعد أكثر من عام على إطلاق سراحه، حدَّدَ فيها مبكراً، وفي حياة حافظ الأسد، ملامح المخرج الديمقراطي، وأعلنَ مطالب ستتكرّر في كل البيانات التي سترى النور فيما بعد، من مثل إلغاء حالة الطوارئ وإطلاق الحريات السياسية والإفراج عن المعتقلين السياسيين. قال رياض الترك: «إني حرّ بمعنى خروجي من السجن الصغير الى السجن الكبير، وعلينا جميعا أن نسعى إلى فتح أبوابه… أنا لا أعتبر إطلاقي منحة من السلطة أو حالاً من التسامح، إذ أن خروجي من السجن كان حقي والحقوق تُنتزَع ولا تُستجدى. أنا لن أتخلى عن حقي في ممارسة السياسة مهما تكن الظروف، وأهلاً بالسجن إذا كان ثمناً للتمسُّك بالرأي».
وأشارَ ابنُ العم في المقابلة ذاتها إلى أن «للإخوان المسلمين كحزب سياسي الحق في الوجود والعمل السياسي. ولكن عليهم أن ينبذوا طريق العنف وأن يسيروا في الاتجاه الديمقراطي». أما عن صمت المجتمع الذي صدمه غداة الإفراج عنه، فأجاب متلمِّساً ما سيحدث بعد شهور قليلة مع ولادة بيان الـ99 وبداية حراك ربيع دمشق: «لم يبقَ للمجتمع إلا الصمت ليعبر من خلاله عن وجوده وعن رفضه للوضع القائم. إذاً، الصمت هنا موقف، لكن هذا الصمت لا يمكن أن يدوم طويلاً ولا بدّ للمجتمع من أن يفرز تعبيرات جديدة تنتمي إلى عالم البيانات والمواقف العلنية والفعل».
تأبطّتُ نصَّ المقابلة وسافرتُ مسرعاً إلى بيروت، إلى مكتب الصديق جوزيف سماحة في جريدة الحياة راجياً منه نشرها. طلب جوزيف التريّث حتى يستمزج إمكانيات النشر، خوفاً من أن يُغلَق مكتب الحياة في دمشق.
بعد طول انتظار دام لأكثر من شهر، تم تحديد موعد النشر في 17 كانون الثاني (يناير) 2000. اتصلتُ بابن العم راجياً منه أن يتّخذ احتياطاته تحسُّباً لرد فعل السلطة. رفض الفكرة بشدة، وقال بغضب: «أنا ماني تارك مكاني! إذا بدهم ياني، يجو ياخذوني من البيت».
أما أنا، فخشيتُ في حال تمّ اعتقال رياض الترك أن أُتَّهمَ بأنني ورَّطته بطيشي وبقيتُ حراً طليقاً في بيروت! فسافرتُ عائداً الى دمشق عشيّة نشر المقابلة، وقرّرتُ أن أتخفَّى بانتظار ردِّ فعل السلطة، لأنني كنت بالتأكيد لا أريد أن اختبر سجون الأسد من الداخل بعد أن خَبِرتُها وعِشتُها من الخارج.
مرّ نشرُ المقابلة بسلام في فترة كانت السلطة فيها منشغلة بالتسويق لمشروع التوريث. تم منع العدد فقط، لكن رفاق رياض الترك تكفَّلوا بتوزيع آلاف النُسخ المُصوَّرة من المقابلة، وكان لها وقع الصاعقة على رؤوس بعض المعارضين، قبل الموالين.
أذكرُ كيف أنني حاولت شامتاً تخيُّلَ مشاعر الغضب التي انتابت حافظ الأسد عند قراءته لهذه المقابلة، هذا في حال قرأها! لأُدرِكَ لاحقاً أنه لم يعد مهماً إن كان قرأها أم لا، المهمّ أن رياض الترك بعد 18 عاماً من السجن عبّرَ علناً عن رأيه المعارض في حياة سجانه وفي ذروة جبروته.
توفي الأسد في 10 حزيران (يونيو) من العام 2000، وتم تعديل الدستور في دقائق معدودة لتمكين بشار الأسد من وراثة أبيه، وتوافدَ زعماءُ العالم للمشاركة في الجنازة ومباركة مشروع التوريث. ذهبتُ لرؤية ابن العم برفقة الصديق الصحافي جيل باريس، فأدلى له بتصريح نشرته صحيفة لوموند بتاريخ 28 حزيران من العام 2000، قال فيه: «هذه التغييرات ليست مفاجئة. أصبحت سوريا في سيكولوجية حافظ الأسد ملكاً شخصياً له، وعليه أن يورثها… إنهم يستهزئون بالشعب. إنه دليل على أن لا شيء يتغير. إنها مهزلة! لن أذهب للتصويت لبشار الأسد وأقولُ ذلك علناً، على أي حال، هو لا يحتاج إلى صوتي، فقد تم انتخابه بالفعل من خلال التزوير الانتخابي الذي يصادر إرادة الشعب».
كان رياض الترك يومها الصوتَ الوحيد الذي ارتفعَ عالياً من داخل سوريا احتجاجاً على مهزلة تعديل الدستور. كان لسانَ حال ملايين السوريين، الذين شعروا بالعار والخزي للطريقة التي تم فيها توريث السلطة.
غداة تبوء بشار الأسد سدة الرئاسة، نشرنا لابن العم بتاريخ 22 تموز 2000 في ملحق النهار نصَّه الشهير «إلى متى تبقى سورية مملكة الصمت؟»، بيّنَ فيه رؤيته لمعالم التحرُّكِ المعارض بعد أن فُرِضَ التوريث، داعياً الى كسر حاجز الخوف، مُستلهماً في ذلك نضال المنشقين في أوروبا الشرقية ضد الأنظمة الشمولية، ومُستشهِداً بكتابات المسرحي والمنشق التشيكي فاتسلاف هافل وصولاً إلى سقوط جدار برلين. كتبَ واصفاً الوضع في سورية: «لا يزال الخوف جاثماً على الصدور، ولا تزال تتولد عنه طقوس من الطاعة والإذعان يعرف القيّمون عليها والمشاركون فيها زيفها وبُطلانها». وأضاف أن أي حلّ سياسي يجب بحسب عباراته أن «يُنزِل السلطة من عليائها ويَنزعَ عن رموزها صفة القداسة». وفي ظل ضعف أي حامل سياسي لهكذا مشروع، أشارَ ابن العم إلى «إنَّ مهمة كل سياسي ونقابي ومثقف وكاتب، بما يملكه في مجاله من رأس مال رمزي وثقل معنوي، هي المساهمة في إخراج شعبنا من بحر الأكاذيب إلى برّ الحقيقة، وذلك بشتى الطرق السلمية كالنضال العلني والبيانات المُوقَّعة والرأي الحرّ الفردي والجماعي».
لم يَطُل انتظار ابن العم طويلاً، وجاء الردُّ هذه المرة في البيان الذي وقعه 99 مثقفاً سورياً من سينمائيين وشعراء وكتّاب في 27 أيلول (سبتمبر) من العام 2001. فقد كسروا فيه حاجز الخوف، وطالبوا بإطلاق الحريات السياسية، وتلاه بيان الألف وبيان المحامين وإطلاق المنتديات وتحرُّر الكلام للتأكيد على المطالب ذاتها، فيما بات يُسمّى بربيع دمشق.
والحقيقة التي يجب أن تُقال هنا أن رياض الترك لم يكن وحيداً في رفع الصوت المعارض في تلك الفترة، لكنه كان بالتأكيد الصوت الأجرأ والأكثر تأثيراً، لا بل إن جُرأته شجعت الكثير من الناس على الكلام، لكنها في ذات الوقت كانت إشكالية بالنسبة إلى بعض أصدقائه، قبل أعدائه. فهو بسقف كلامه المرتفع، لم يتحدَّ القهر والظلم فقط، ولكنه فضح الخوف والإذعان الذي استبطن في نفوس الكثير من الناس وبالأخص منهم بعض المعارضين. حريته في مكان ما كانت إشكالية لأنه برهن للجميع أن إرادة الإنسان أقوى من كل القيود، وفي الأخص منها القيود الذاتية التي يكبّل الناس أنفسهم بها. كان ابن العم، على عكس ما قد يُظَنُّ به، متفهِّماً لخوف وتردُّد بعض المعارضين في مجاراته بتحدي السلطة، وكان يُردِّد أن في الإسلام هناك ما يسمى «فرض كفاية» إذا قام به بعضهم سقط عن الآخرين. لكن تفهُّمه هذا سرعان ما يتحول إلى غضب عارم في حال حاولَ بعض الخائفين أو المترددين أن يخفضوا سقف الخطاب العام المعارض ليتلاءم مع سقوفهم المنخفضة ومع الخطوط الحمر للسلطة. بالمقابل كان البعض من ضعاف النفوس لا يتقبل حتى فكرة أن التكلُّم علناً بهذا السقف المرتفع، أو المبادرة بإجراء مقابلة أو قبول المشاركة في فيلم وثائقي، يمكن أن يتم بمبادرة ذاتية، فراحَ يُروِّج أن مثل هذا الأفعال والأقوال لا يمكن لها أن تحدث من دون ضوء أخضر أو قبول ضمني من السلطة!
بعد عام تقريباً من بداية ربيع دمشق، ألقى رياض الترك محاضرته في منتدى الأتاسي بتاريخ 5 آب 2001، مُقترِحاً فيها طريقاً للتوافق السلمي من أجل نقل سورية من حال الاستبداد إلى الديمقراطية. ورغم الـ 18 عاماً التي أمضاها في السجن من دون محاكمة، أعلن استعداده لطي صفحة الماضي وتدشين عهد جديد تحت سقف حرية الوطن والانتقال الديمقراطي التدريجي بعيداً عن النظام «الجمهوري الوراثي». في النقاش الذي أعقب المحاضرة في منتدى الأتاسي، سقطت الحواجز وتدافعَ الحضور على الكلام الحرّ الذي طالما حُرموا منه، وصار لسان حالهم كأنه لسان رياض الترك.
بعد المحاضرة أجرى ابن العم مداخلة هاتفية على الهواء ضمن برنامج «بلا حدود» على قناة الجزيرة في نهاية شهر آب (أغسطس)، مؤكِّداً على الأفكار التوافقية ذاتها، ومُذكِّراً السوريين وأهل النظام تحديداً بأن الديكتاتور قد مات. وقع كلام ابن العم كالصاعقة على رؤوس السوريين، ليس فقط لأنه وَصفَ الرئيس الراحل بالديكتاتور، ولكن لأنه نبَّههم وذكَّرهم بأنه حقاً مات، في حين أن توازنات السلطة ومعادلاتها كانت تعمل (وربما لا تزال) لتُوهِمَهم بأنه حي ومؤبد من خلال ابنه بشار.
كان عصب المنظومة الأسدية قائماً على دائرة مغلقة من العنف الذي يُولِّدُ الخوف الذي يُولِّدُ التكاذب المُعمَّم والنفاق. أتى ابن العم ليُخلخلَ هذه الدائرة، فلم يَقُل فقط إن الملك عارٍ، ولكنه نزعَ ورقة التوت الأخيرة عن كل المتواطئين والمشتركين بالتكاذُب الجماعي. بعد هذه المداخلة، بات مستحيلاً على السلطة أن تُداري عُريها، ليس فقط في عيون رعاياها ولكن في عيون أهل السلطة أنفسهم، فلم تجد حلاً أفضل من سياسة الهروب إلى الأمام بإعادة رياض الترك مجدداً إلى السجن، وتم من بعدها إغلاق المنتديات تباعاً واعتُقِلَ أبرزُ المعارضين وطُويت إلى حين صفحة ربيع دمشق.
بقي ابن العم في سجنه الجديد قرابة العام والنصف، وانضمت «حبسة بشار»، كما كان يحلو له أن يسميها تصغيراً، إلى «حبسة حافظ» و«حبسة السراج» و«حبسة الشيشكلي».
بعد خروجه من سجنه الأخير، عاد رياض الترك إلى النشاط السياسي كسابق عهده. ومع غزو العراق، أخذ موقفاً واضحاً ضد الاحتلال، رغم محاولة بعض المتصيدين في الماء العكر أن يُحرِّفوا أقواله وينسبوا له ما لم يَقُل. وبعد اغتيال الحريري وانسحاب الجيش السوري من لبنان، أدان عمليات الاغتيال في لبنان وطالب بشار الأسد بالاستقالة، وأصرَّ على أهمية التغيير من الداخل السوري في مواجهة التهديدات الأميركية للمنطقة، وراح يعمل ويدفع باتجاه تشكيل تحالف داخلي عريض للتغيير الديمقراطي يضم كل أطياف المعارضة بما فيها الإسلاميون والأحزاب الكردية، ليُولَدَ هذا التحالف في تشرين الأول (أكتوبر) من العام 2005 تحت مسمى إعلان دمشق.
قد يظن البعض أن الهدف الرئيس من وراء هذا التحالف كان تحشيدَ كل القوى المعارضة في مواجهة النظام، لكن الهدف الأبعد الذي سعى إليه ابن العم تجسَّدَ في إدراكه أنَّ لا قيام لحياة ديمقراطية سليمة من دون أن تشترك فيها كل التيارات السياسية الفاعلة بما فيها التيارات الإسلامية، بشرط أن ترتضي بالاحتكام الى صندوق الاقتراع وبمبدأ التناوب على السلطة وباحترام حقوق الأقليات السياسية والدينية. وسيكون هذا النزوع الفكري والسياسي لاحقاً في صلب ثورات الربيع العربي.
في بداية آذار (مارس) من العام 2011 سافرتُ إلى دمشق بعد انقطاع دام لفترة طويلة. كانت معظم القوى المعارضة تظن أن رياح التغيير التي هبت على العالم العربي ستقفُ على أبواب دمشق، بسبب جبروت النظام وحساسية الصراع مع إسرائيل. أما ابن العم فكان واثقاً أنها «ستفقع عندنا» بحسب عباراته، وأن الشباب هم الذين سيفقعونها، لا أحزابُ المعارضة المتخاذلة كما كان يحلو له تسميتها. ومن تلك الزيارة عدتُ أحمل في جعبتي مقالة جديدة من ابن العم، عَنونها هذه المرة «لن تبقى سورية مملكة الصمت». جملة قطعية وخالية من أي إشارة استفهام على عكس مقالته التي نشرها بداية ربيع دمشق، وعَنونها مُتسائلاً: «إلى متى تبقى سورية مملكة الصمت؟».
نُشرت هذه المقالة في جريدة القدس العربي بتاريخ 11 آذار 2011 عشية اندلاع الثورة السورية، وكتب فيها رياض الترك أن «رياح التغيير التي هبت في الأشهر الثلاثة الأخيرة على كل العالم العربي من أقصاه إلى أقصاه، لا يمكن لها في النهاية إلا أن تطرق باب السجن السوري الكبير. لقد سقط حاجز الخوف الذي جثم على كاهل الشعوب العربية لعقود طويلة… التغيير آت لا محالة، وسورية لم ولن تكون أبداً الاستثناء. كل ما أعرفه اليوم أن سورية لن تبقى مملكة الصمت، ولن يبقى الخوف مطبقاً على الصدور، ولن يبقى الوطن سجناً كبيراً».
بعد بضعة أيام اندلعت الثورة السورية و«فقعت» في كل أرجاء السجن السوري الكبير. لم يكن ابن العم يومها مُنجِّماً أو ضارباً بالغيب، لكنه بنى استقراءه على بصيرة سياسية وإيمان عميق بأن هذه الثورة منتصرة ولو انهزمت، ومن هذه الصيرورة التاريخية لا بد في النهاية أن تُولدَ سورية الجديدة.
في 27 تموز 2011 نشرتُ في جريدة الحياة المقابلة الأولى له منذ اندلاع الثورة، وسألته عن سبب غيابه عن الإعلام فأجاب: «سبب صمتي عائد في جزء كبير منه إلى رغبتي في أن تُعطى الحقوق إلى أصحابها. الآن الكلام للشارع. الكلام للشباب الثائر. الكلام لمن يصنع الحدث. الكلام للشعب الذي يخرج اليوم عن صمته ويقوّض جدران مملكة الصمت»؛ وأضاف «لقد نشأ وضعٌ في الماضي كنتُ فيه من بين القلائل الذين رفعوا صوتهم جهراً بالحقيقة، لكننا اليوم أمام شعب يخرج عن صمته ويصنع لغته ويصوغ شعاراته ويبدع تحركاته، فلنستمع له بتأنٍ، ولنمشي معه لا أمامه».
وهكذا فعلَ رياض الترك خلال سنوات الثورة المديدة، حيث بقي يعمل لها قلباً وقالباً، بتواضع جمّ ونكران للذات، يعمل في النشاط السرّي بعيداً عن الأضواء وعن نجوم التلفزيونات من المعارضين الطارئين، وذلك حتى تاريخ خروجه إلى فرنسا في العام 2018.
أنضمَّ ابن العم في النهاية الى ملايين السوريين في المنفى، وظلَّ يشعر الى آخر لحظة بنفسه وكأنه سمكة أُخرِجَت من بحرها، مؤكِّداً أن العمل المُجدي والأساسي هو داخل سورية، وأن الأولوية اليوم هي لإخراج القوى الأجنبية من أرضنا وعودة اللاجئين.
خلال السنوات الخمس الم اضية، لم أنقطع عن ابن العم التسعيني، وحاولتُ مواكبته بالكاميرا كلما سنحت لي الفرصة. كانت شيخوخته غاية في الوقار. تباطأَتْ حركته وانخفضت نبرة صوته وخفَّت حِدّة نظراته، لكن ملكاته العقلية بقيت على حالها حتى آخر لحظة. كان يُعابِثُني في كل مرة أفتح الكاميرا متسائلاً عن مدى تمكني من فن التصوير، وكان يصرّ عليّ أن ألتفتَ في مشاريعي القادمة لجيل الشباب وأكفّ عنه، وألّا أكرر نفسي، لأنه ينتمي الى الماضي وعليَّ أن ألتفتَ إلى المستقبل. وكنتُ أُجيبه دائماً أن قصّتي معه لم تنته بعد، وأن هناك شيئاً لا يزال يدفعني للمضي قدماً.
اضية، لم أنقطع عن ابن العم التسعيني، وحاولتُ مواكبته بالكاميرا كلما سنحت لي الفرصة. كانت شيخوخته غاية في الوقار. تباطأَتْ حركته وانخفضت نبرة صوته وخفَّت حِدّة نظراته، لكن ملكاته العقلية بقيت على حالها حتى آخر لحظة. كان يُعابِثُني في كل مرة أفتح الكاميرا متسائلاً عن مدى تمكني من فن التصوير، وكان يصرّ عليّ أن ألتفتَ في مشاريعي القادمة لجيل الشباب وأكفّ عنه، وألّا أكرر نفسي، لأنه ينتمي الى الماضي وعليَّ أن ألتفتَ إلى المستقبل. وكنتُ أُجيبه دائماً أن قصّتي معه لم تنته بعد، وأن هناك شيئاً لا يزال يدفعني للمضي قدماً.
في نهاية آخر جلسة تصوير معه قبل عدة شهور، وضعتُ على الطاولة البيضاء التي كانت تفصل بين الكاميرا وبينه صحناً مليئاً بحبات العدس، وطلبتُ منه أن يرتجلَ أي رسم يخطر على باله. تمنَّعَ ابنُ العم بداية، ووافق في النهاية أمام إلحاحي الشديد. بدأ ابن العم بِصَفّ حبات العدس لتشكيل إطار الأرابيسك، ودخل في حالة من الوَجد الصوفي والانقطاع عن العالم الخارجي، كما في كل مرة يبدأ فيها الرَّسَمَ بالحبات السوداء.
فجأة توقَّفَ ابنُ العم عن الرسم وراحَ يتأمل لثوانٍ طويلة إطار الأرابيسك الفارغ من الداخل من دون أن يأتي بأي حركة. لوهلة خِلتُهُ يفكر ماذا سيَخطُّ داخل الإطار، ثم شَككتُ أنه ربما قد غفى أو ذهبَ في أفكاره بعيداً نحو زنزانته. لكنّه بعد دقائق مديدة وعصيبة، علينا نحن الإثنان، رفع رأسه باتجاه الكاميرا ونظر إليَّ وقال: «خلص! ما عاد فيني كمل…».
مسحَ ابنُ العم بهدوء وبحركة واحدة من يده حبات العدس من على سطح الطاولة وأعادها جميعاً إلى الصحن، وأطفأتُ أنا كاميرتي، وبقيت المساحة البيضاء فارغة وصامتة بيننا.
مساحة بيضاء سيكتبُ عليها ويرسمُ فيها جيلٌ شابٌ معنىً جديداً لسورية الحرة والقادمة، سورية التي طالما حلم بها وناضل من أجلها رياض الترك.
الجمهورية



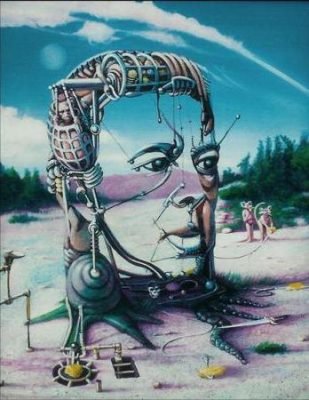

المزيد من المواضيع
تحول تاريخي: الاعتراف الرسمي بحقوق الكرد السوريين وإعادة تعريف الشراكة الوطنية
حين يصبح السلاح عبئاً على الأكراد… حلّ قسد لم يعد خياراً
هل تُهدّد الترتيبات الأمنية مكانة الجولان كأرض سورية محتلة؟