 أكدت مصادرنا في اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سورية الراصد بأنه تم استدعاء المحامي الأستاذ أنورمحمد فائق مسلم من قبل فرع الأمن السياسي بحلب في يوم الثلاثاءالماضي الواقع في11/1/2011 ومنذ ذلك الحين انقطعت اخباره، علما بانه لم يتم احالته الى اية جهة قضائية حتى لحظة اعداد هذا البيان ويعتتقد بان اعتقاله تم على خلفية ارائه وميوله السياسية.
أكدت مصادرنا في اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سورية الراصد بأنه تم استدعاء المحامي الأستاذ أنورمحمد فائق مسلم من قبل فرع الأمن السياسي بحلب في يوم الثلاثاءالماضي الواقع في11/1/2011 ومنذ ذلك الحين انقطعت اخباره، علما بانه لم يتم احالته الى اية جهة قضائية حتى لحظة اعداد هذا البيان ويعتتقد بان اعتقاله تم على خلفية ارائه وميوله السياسية.
وجدير بالذكر بان المحامي أنور محمد فائق مسلم والدته مدينة هو من مواليد منطقة عين العرب (كوباني) عام 1976 انتسب الى نقابة المحامين فرع حلب منذ عام 2000 متزوج وله ولدين مقيم في حلب حي الشيخ مقصود، وبذلك يكونانور قد انضم الى كل من المحامين الكرد الاساتذة مصطفى اسماعيل ومحمد مصطفى والى كل من الاساتذة مهند الحسني وهيثم المالح والى باقي معتقلي الراي والضمير القابعين في سجون البلاد دون وجه حق
من جهة اخرى تاكد لنا خبر إحالة الموقوف عرفيا أحمد حسن بن شيخ علي من مواليد عين العرب مقيم في مدينة الرقة إلى القضاء العسكري بحلب بتهمة “الحض على النزاع بين عناصر الأمة بقصد إثارة النعرات الطائفية والمذهبية في البلاد” المنصوص عليها بالمادة/307/ من قانون العقوبات العام، وكذلك تم إحالة كل من الشقيقين نظمي محمد نبي و صبري محمد نبي إلى قاضي الفرد العسكري بالرقة بنفس التهم المذكورة أعلاه.
وفي حلب ايضا كانت محكمة الجنايات العسكرية بحلب قد أصدرت حكما غيابيا بالسجن عشر سنوات بالقرار رقم/586/لعام2010 في الدعوى رقم /571/لعام2010 بجناية “الانتساب إلى جمعية سياسية محظورة يهدف إلى الاقتطاع لجزء من الأرض السورية لضمه إلى دولة أجنبية” والمنصوص عليه بالفقرة الثانية من المادة/267/من قانون العقوبات العام،على المدعى عليهم
– الطالب أحمد يوسف بن وليد والدته أمينة تولد قره تبه 1981 وهو طالب جامعي- سنة رابعة أدب عربي في جامعة حلب. .
– الطالب جفان الشاويش بن عبد الرحمن والدته ونسة تولد تل خنزير فوقاني- من أهالي ديريك- الحسكة، وهو طالب ماجستير في جامعة حلب.
– الطالب عبدو رستم بن زهني والدته زهيدة تولد أحرص-منطقة اعزاز1982 وطالب سنة رابعة أدب عربي في جامعة حلب.
– جزو رمو بن عيسى والدته جميلة تولد بيلو يران 1953 كوباني، وهو موقوف حاليا.
– عبد الرحمن محمد علي بن علي والدته أمينة تولد بيلويران 1988 كوباني.
ومن جهة اخرى وفي القامشلي كان من المفترض أن تجري اليوم الأحد الواقع في 16 / 1 / 2011 جلسة محاكمة الكاتب الكردي الأستاذ عبد السلام حاجي إبراهيم ( سيامند إبراهيم ) بالدعوى رقم أساس ( 417 ) لعام 2011 والتي كانت مخصصة للدفاع، ولكن القاضي قرر تأجيل موعد جلسة المحاكمة إلى يوم الأربعاء 19 / 1 / 2011 بسبب عدم إحضاره من سجن القامشلي إلى المحكمة.
يذكر أن التهمة الموجهة إلى الأستاذ عبد السلام حاجي إبراهيم ( سيامند إبراهيم )، هي جنحة: القيام بأعمال يقصد منها أو ينتج عنها إثارة النعرات العنصرية أو الحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمة المنصوص عنها في المادة ( 307 ) من قانون العقوبات السوري العام.
علما بانه تم توقيفه بتاريخ 25 / 11 / 2010 اثر استدعاءه إلى الأمن السياسي بالقامشلي، ليتم تحويله فيما بعد إلى فرع الأمن السياسي بالحسكة، وبعدها تم تحويله إلى القاضي الفرد العسكري الذي استجوبه يوم الأحد 28 / 11 / 2010 وهو من مواليد 1955 متزوج وأب لأربعة أطفال.
كما اكدت المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، بأن عناصر أمنية تابعة للأمن الجوي في محافظة دير الزور، قامت في حوالي الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الثلاثاء الواقع في 11 / 1 / 2011 بتطويق قرية غلي تحتاني التابعة لناحية عاموده – محافظة الحسكة، ومداهمة منزل السيد فارس حسو محمد واعتقاله مع ولده دانيش فارس محمد، واقتيادهما إلى جهة مجهولة، وذلك على خلفية وشاية مغرضة من شخص يختلفون معه على أرض زراعية.
وعلم لاحقا أن إحدى الجهات الأمنية بدمشق، قامت مساء يوم السبت 15 / 1 / 2011 باعتقال ولده الآخر المحامي سعود فارس محمد، واقتياده إلى جهة مجهولة، حيث انقطعت صلته بالعالم الخارجي. ويعتقد أن اعتقاله يأتي على خلفية نفس الوشاية.
يذكر أن السيد فارس حسو محمد من أهالي قرية غلي تحتاني التابعة لناحية عاموده – محافظة الحسكة، ومن مواليد 1945 محل ورقم القيد باب الخير خـ 30 / 9 يعاني من مرض الضغط والسكري.
أما ولده دانيش فارس محمد فهو من مواليد 4 / 3 / 1966 وولده المحامي سعود فارس محمد فهو من مواليد الشهر السابع 1972 ويمارس مهنة المحاماة في العاصمة دمشق.
إننا في لجنة الراصد لحقوق الإنسان ندين ونستنكر اعتقال المحامي انور فائق مسلم ونطالب باطلاق سراحه فورا دون اي قيد او شرط ونطالب باخلاء سبيل الكاتب الكردي سيامند ابراهيم وكافة المعتقلين المذكورين اعلاه،معبرين عن قلقنا البالغ ازاء مايطال المحامين من استدعاءات امنية واعتقالات ودعاوى مسلكية تستهدف نشطاء حقوق الانسان منهم بهدف ممارسة المزيد من الضغوطات عليهم بغية النيل من عزيمتهم في الدفاع عن حقوق الانسان في سورية ، كما نشعر بالمرارة ازاء إصدارهذه الأحكام القاسية والجائرة بحق الطلبةالكرد مطالبين بوقف هذه الاحكام والكف عن حملات الاعتقال التعسفي وطي صفحته بشكل نهائي واطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين والغاء حالة الطوارئ0
دمشق في 16/1/2011
المكتب الاعلامي للجنة الكردية لحقوق الانسان في سورية الراصد
kurdchr@gmail.com
radefmoustafa@hotmail.com



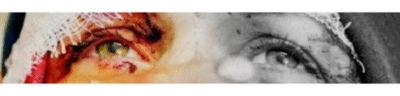

More Stories
البيان المشترك حول السويداء: أثر الإخفاقات الحكومية على تدويل الملف
ازدهار الرجعيات السياسية: الثورة على قيم الزيف المعاصر.
الغياب القطري عن المشهد السوري: ماذا يحدث وراء الكواليس؟